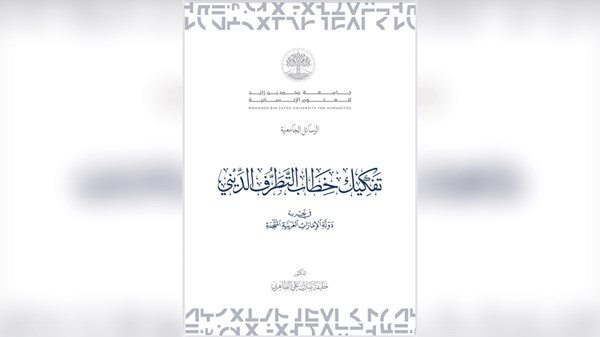أ.د. محمد الخشت
يظلّ خطاب التطرف الديني أحد أخطر التحديات التي تواجه المجتمعات المعاصرة. فهو لا يقتصر على تبنّي أفكار متشددة ضد المدنية فحسب، بل يكرّس منظومة خطابية تُعيد إنتاج الكراهية والحروب والإقصاء تحت غطاء ديني. ومن أسفٍ، يشهد الواقع المعاصر تصاعداً لخطابات التطرف الديني التي أسهمت في تأجيج النزاعات وإضعاف الروابط المجتمعية، بل أدت إلى حروب طائفية وأهلية نتجت عنها مآسٍ إنسانية ضخمة، من أول فقدان الديار إلى فقدان الأرواح والأوطان. ولا شك أن هذا دفع كثيراً من الدول العاقلة إلى مواجهة الفكر المتطرف مبكراً، حفاظاً على الوطن والمواطن، وكان من ضمن جهودها ظهور مقاربات فكرية وفقهية رصينة لإعادة بناء الخطاب الإسلامي.
وفي هذا السياق تندرج دراسة «تفكيك خطاب التطرف الديني: دراسة فقهية تحليلية» للمفكر الإماراتي الدكتور خليفة الظاهري، بوصفها محاولة منهجية لتأصيل مفهوم التفكيك من داخل البنية الفقهية، وآلية علمية لكشف الانحرافات المفاهيمية بالعودة إلى الأصول والمقاصد الشرعية. وهي دراسة تجمع بين التحليل الفكري والقراءة الواقعية، مستنداً فيها المؤلف إلى تجارب حيّة في التصدي للتطرف، وفي مقدمتها التجربة الإماراتية.
وتكشف الدراسة أن خطاب التطرف ليس وليد لحظة تاريخية عابرة، بل نتيجة تراكمات فكرية واجتماعية وفقهية. ويقوم هذا الخطاب على الانتقائية في النصوص، أي اجتزاء الأدلة الشرعية من سياقاتها لتبرير العنف، وعلى إلغاء العقل كأداة لفهم الدين، ثم تحويل التكفير إلى أداة لإقصاء ونفي الآخر.

ويعتمد التحليل في هذه الدراسة الرصينة للدكتور خليفة الظاهري على منهج متكامل ينطلق من تفكيك البنى النفسية والاجتماعية المغذية للتطرف، ثم إعادة بنائها في ضوء مقاصد الشريعة. فالتفكيك هنا ليس إلغاءً تاماً، بل هو تفكيك يعقبه إعادة بناء للمفاهيم، بما يحفظ الثوابت العقدية ويؤسس في الوقت ذاته لقيم التعايش. ومن هذا المنطلق، تتحول الدراسة إلى مرجع يمدّ الفقهاء وصناع القرار بأدوات نظرية وتطبيقية، مستندة إلى مبادرات عالمية مثل وثيقة أبوظبي للأخوة الإنسانية التي أبرزت قيمة «المشترك الإنساني»، باعتبارها مندرجة تحت مقصد حفظ النوع الإنساني.
وعليه، تُظهر الدراسة أن دور الدولة في مكافحة التطرف تجاوز دائرة الإمكان إلى مرتبة الوجوب الشرعي والسياسي، وفق ما تقرره قاعدة «ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب». وبهذا تغدو التجربة محل بحث فقهي مقاصدي يُعيد صياغة الخطاب الديني بما يلائم التحولات العالمية ويصون ثوابت الأمة.
منهجية تحليلية معمقة
يعكس المنهج المعتمد في هذه الدراسة قدرة على دمج التحليل النظري مع التطبيق العملي، مما يجعله أداة فعالة لمواجهة التحديات المختلفة الناتجة عن التطرف. ويقدم المؤلف إطاراً يتجاوز الوصف إلى الإصلاح، مستنداً إلى هيكل ينقسم إلى ثلاثة أبواب رئيسة تغطي المفاهيم والأسباب والحركات المعاصرة، والمحددات المنهجية وآلية تصحيح المفاهيم المفجرة، والتطبيق النموذجي لتفكيك خطاب التطرف الديني في دولة الإمارات.
وتتمثل أكبر ميزة منهجية رئيسة في المنهج التحليلي المتكامل، الذي يبدأ بتحديد المفاهيم الأساسية في الباب الأول. وتستخدم الدراسة «التفكيك» بوصفه تفكيكاً منهجياً «وهو التفكيك الذي يكون وسيلة إلى إعادة النظر في النصوص وتشريحها، من أجل بناء أرضية سليمة وقوية، والخروج من جمود النص، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وتقرير المقاصد الكبرى للشريعة الإسلامية السمحة. ومن دون (التفكيك المنهجي)، الذي يدعو إليه كثير من الحكماء والعقلاء في عصرنا الحالي، لا يمكن الخروج من الأغلال الجامدة، والجمود القاتل، والمفاهيم السقيمة، التي بثها المتطرفون في عصرنا الحالي».
وهكذا تقوم الدراسة بعملية تحليلية وتفكيكية لخطاب التطرف، مع التركيز على مداخله النفسية والاجتماعية والاقتصادية. وهذه العملية ليست سطحيةً، بل تدعم بتحليل لأسباب التطرف كظاهرة متعددة الأبعاد، حيث تفحص مختلف العوامل الدينية والاجتماعية والنفسية والاقتصادية. ويُقارن الدكتور الظاهري بين حركات، مثل الإخوان المسلمين والقاعدة، موضحاً كيف يُحرّف الخطاب المتطرف مفهوم الجهاد إلى عنف غير مشروع، مع تجاهل نصوص مثل قوله تعالى: (وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ) (البقرة: 190).
المقاصد الشرعية كإطار لتصحيح المفاهيم
يرتكز العمل على إبراز المقاصد الكبرى للشريعة، مثل: حفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ الدين، وحفظ المال، وحفظ النسل والأعراض. هذه المقاصد تُظهر أن الدين جاء لحماية الحياة، لا لهدرها. بهذا الإطار، يصبح خطاب التطرف متناقضاً مع جوهر الدين نفسه. وهنا يكمن البعد التجديدي للدراسة: الدعوة إلى العودة إلى النصوص بروحها ومقاصدها، لا بحرفيتها الجامدة.
ومما تتميز به الدراسة، هو تركيزها على توظيف المقاصد الشرعية لتصحيح المفاهيم المحرفة، وهو جوهر الباب الثاني الذي يقدم محددات منهجية للتفكيك، خاصة أنه لا يقف عند التشخيص، بل يتقدّم بخطوات عملية للتفكيك. في مقدمة هذه الخطوات إعادة ضبط المفاهيم التي اختطفها المتطرفون. فمفهوم الجهاد يُردّ إلى معناه الأصيل المرتبط بالدفاع المشروع، لا بالاعتداء. ومفهوم الحاكمية يُفهم في سياقه التاريخي والفكري، بعيداً عن التوظيف السياسي الذي يجعل من الدين أداةً للسيطرة. كذلك يعاد النظر في مفهوم الولاء والبراء، ليكون أداة للعدالة الاجتماعية بين كل الملل والطوائف وتحقيق الكرامة الإنسانية للجميع تحت مظلة الدولة الوطنية، مستشهداً بقوله تعالى: «لاَ يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُواْ إِلَيْهِمْ» (الممتحنة: 8، ص 247). هكذا، يُحوّل التصحيح من نظرية إلى أداة عملية، مُعزِّزاً التماسك الاجتماعي والثقافي والسياسي.
وفي هذا السياق، يُعالج المفاهيم العقدية المفجرة، مثل «ثنائية الكفر والإيمان»، حيث يؤكد أن التكفير له شروط مشددة، كما يُحذِّر من خطورة التكفير كباب فتنة، مقارناً بين التراث والواقع، مما يُبرز مرونة الفقه في مواجهة التحديات المعاصرة.
التجربة الإماراتية: من النظرية إلى التطبيق
يتجاوز البحث المستوى النظري، حيث يعرض تجربة الإمارات في مواجهة التطرف كنموذج عملي حي. فلا شك أن التجربة الإماراتية تأتي مثالاً تطبيقياً يترجم هذا المنظور، حيث أثبتت التقارير الدولية فاعلية السياسات الوقائية التي اعتمدت على تكامل التعليم والتأهيل الفكري مع الإجراءات الأمنية، وهو ما انعكس في خلو الدولة من أي حوادث إرهابية خلال الأعوام الماضية حسب التقارير الدولية الرسمية. وهذه التجربة لا تُقرأ باعتبارها معطى أمنياً فحسب، بل تُفهم في إطار ما يسميه الأصوليون بـ «تحقيق المناط»، إذ نُقلت النصوص إلى الواقع وفق مقاصدها الكلية في صيانة الدين والنفس والمجتمع.
وقد تناول الكتاب تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في تفكيك خطاب التطرف الديني، في الباب الثالث، ويبدأ بـالفصل الأول الذي يعرض الانتقال من مرحلة الإمكان إلى مرحلة الإلزام في معالجة الظاهرة داخل الدولة، متناولاً في المبحث الأول أهمية الإلزامية في ترسيخ قيم التعايش والاعتدال، وفي المبحث الثاني القوانين الاتحادية التي سنتها الدولة لمكافحة التطرف والإرهاب وتعزيز التسامح والتعايش، وتشمل: القانون الاتحادي لمكافحة الجرائم الإرهابية، والقانون الاتحادي لمكافحة التمييز والكراهية، والقانون المتعلق بجرائم تقنية المعلومات، وأخيراً القانون الخاص بغسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. أما المبحث الثالث فيركّز على المراكز الإماراتية المتخصصة في مكافحة خطاب التطرف، مثل مركز هداية وقانون مركز مناصحة.
ويأتي بعد ذلك الفصل الثاني تحت عنوان «وثائق إماراتية خالدة»، حيث يُفرد المبحث الأول لوثيقة إعلان أبوظبي – وثيقة الإخوة الإنسانية، مبيناً سياقها وأبعادها والنتائج التي أسفرت عنها، بينما يخصص المبحث الثاني لإعلان مراكش المتعلق بتحقيق حقوق الأقليات الدينية في العالم الإسلامي، متناولاً سياق المؤتمر وأهدافه ومخرجاته، ثم صحيفة المدنية وأهم بنود الإعلان. وفي المبحث الثالث يتناول الكتاب «حلف الفضول الجديد»، موضحاً سياق المؤتمر وأبعاده، والحاجة إلى إحيائه وأهدافه، ثم يستعرض آلياته ومجالاته ووسائله الأساسية.
رؤية تقدمية تُعيد بناء الخطاب الإسلامي
إذن، تفكيك خطاب التطرف الديني – كما قام به الدكتور الظاهري – ليس مجرد دراسة نظرية، بل مشروع للتجديد الديني وإعادة الاعتبار للخطاب الإسلامي الوسطي. حيث نجح المؤلف في كشف تناقضات خطاب التطرف، وفي طرح بدائل عملية تُعزز قيم المواطنة والسلام والأخوة الإنسانية. وهنا تكمن أهميته: أنه قدم خريطة طريق، يمكن للباحثين والمهتمين وصنّاع القرار الاسترشاد بها في مواجهة أخطر تحديات العصر. كما قدم رؤية تقدمية تُعيد بناء الخطاب الإسلامي، مستندة إلى الثبات والمرونة، في عالم يتسم بالتغير السريع. فضلاً عن توظيف المنهج المقاصدي. وهو منهج أصيل في الفقه الإسلامي، يعيد التوازن بين النصوص والواقع. مع معالجة متعددة الأبعاد: فالتطرف لا يُفهم إلا في ضوء العوامل الفكرية والاجتماعية والسياسية مجتمعة. وتأسيساً على كل ذلك، فإن الدكتور الظاهري لم يكتف بهدم خطاب التطرف، بل استطاع بناء خطاب بديل يقوم على التعايش المشترك تحت ظلال الدولة الوطنية الراسخة البنيان.
عضو المجلس العلمي الأعلى لجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية
رئيس جامعة القاهرة السابق