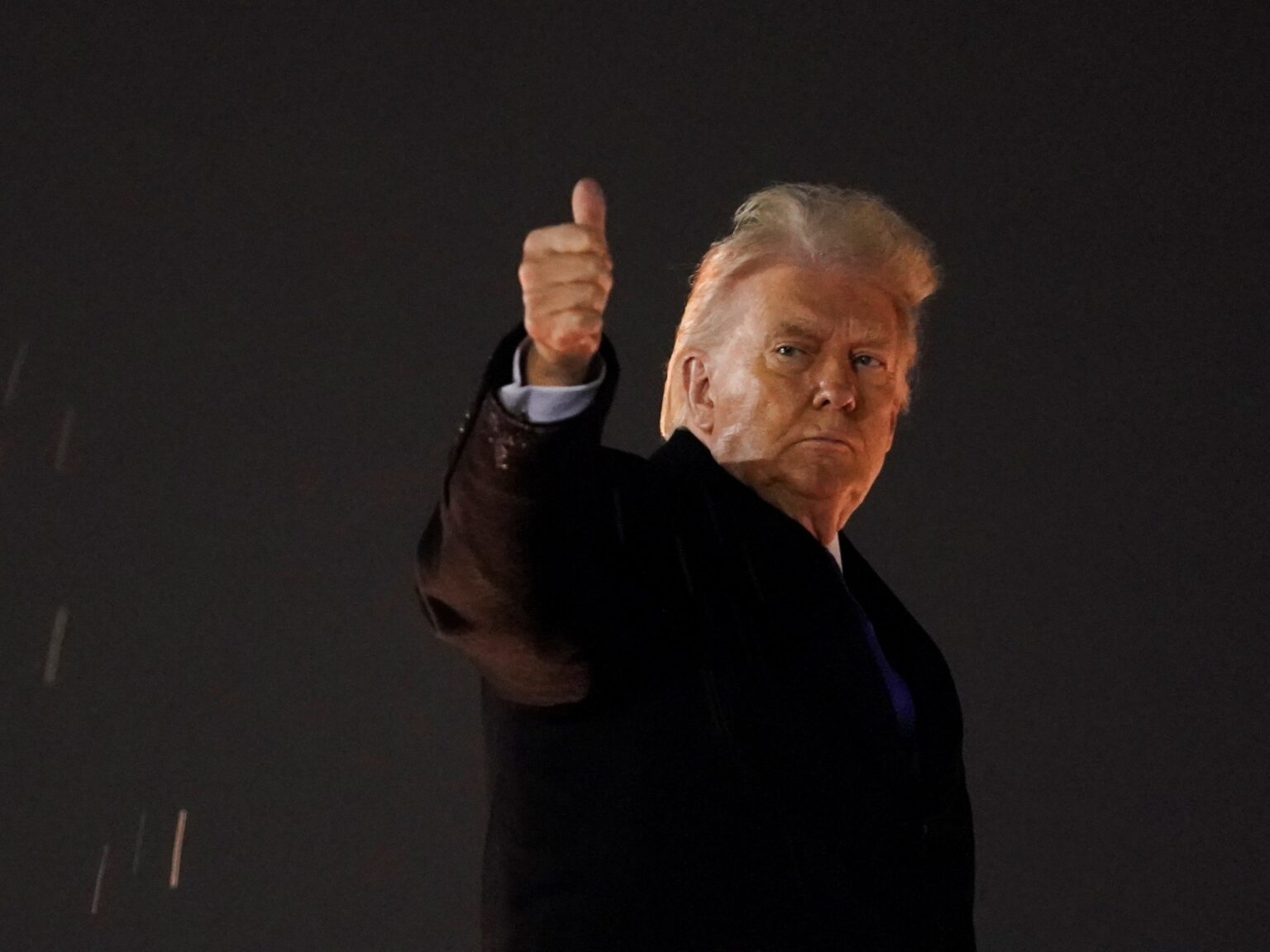لم تسجل مراصد السياسة والإعلام، حالات قلق جدية في أي من العواصم العربية، بعد “غزوة كاراكاس”، فالزمن الذي كان فيه العالم العربي منقسما بين أنظمة “ثورية” وأخرى “محافظة”، انتهى منذ زمن بعيد، قبل أن تأتي موجات “الربيع العربي” على ما تبقى من أنظمة الجنرالات في سوريا وليبيا واليمن…”نادي أصدقاء واشنطن” اتسع كثيرا، وبات يغطي الرقعة العربية من محيطها إلى خليجها.
لكن ذلك لا يعني للحظة واحدة، أن أحدا لم يتحسس رأسه على وقع مشاهد اقتياد نيكولاس مادورو بالأصفاد من غرفة نومه إلى زنزانة في مانهاتن … ليس خشية من إعادة تمثيل المشهد في كاراكاس في أي من عواصمنا، فذلكم سيناريو مستبعد إلى حد كبير، ولكن لخشية من فقدان ما تمتعت به بعضها من “هوامش” وإن محدودة لحرية الحركة والمناورة، مع تصاعد الآمال بولوج المجتمع الدولي عتبات نظام عالمي جديد، قائم على التعددية القطبية، وزيادة الإحساس بتراخي قبضة “القطب الأوحد” على السياسات والعلاقات الدولية.
ومن الآن فصاعدا، ستفكر حكومات وحكام، طويلا ومليا، قبل أن تهمس ويهمسوا بـ”لا” واحدة، ضد هذا السلوك أو تلك السياسة الأميركية.. ستُجري العواصم العربية حساباتها، مرات ومرات، قبل أن تقدم على أي خطوة، من شأنها إثارة غضب واشنطن وما تعتبره مصالح عليا لها، يتعين احترامها وخدمتها، حتى القطرة الأخيرة.
شيء من الأيديولوجيا والإستراتيجيا
في الأيديولوجيا، وقبل 100 عام، أو يزيد قليلا، تحدث فلاديمير لينين عن الإمبريالية بوصفها “أعلى مراحل الرأسمالية”، ولا أحسب أنه وهو في ذروة تشخصيه لجشع رأس المال “المتمركز”، قد تخيل ما يمكن أن يؤول إليه التوحش و”العري” اللذان أصابا هذا النظام في رأسه، وقلب منظومته.. فالإمبريالية في عصرنا الراهن، والأميركية بخاصة، بلغت أعلى مراحل توحشها وعريها، فلا مطرح في قاموسها لقانون دولي، ولا احترام لسيادة الدولة، ولا حصانة لأحد، ولا قيد أخلاقيا يخفف من حدة التعبير عن الشهوة، أو غلواء النهم للاستيلاء على ثروات الغير ومقدراته، من دون مسوغ من أي نوع.. لا اعتبار للحلفاء والأصدقاء والأقربين منهم خاصة، ولا تهاون مع الأعداء الذين توعدهم ترامب، بمثل ما فعل بفنزويلا ورئيسها، وطلب منهم الاصطفاف في الطابور بانتظار جولات تالية.
الإمبريالية الغربية ربحت السباق في الحرب الباردة، بمزيج من الوسائل والأدوات، الخشنة والناعمة، وبتفوقها العلمي والتكنولوجي، وبمنظومات الحكم الديمقراطي والقيم والحقوق.
الإمبريالية اليوم، تقف عاجزة عن الحفاظ على موقعها على قمة العالم والاقتصاد العالمي، بوجود منافسين أقوياء، اقتصاديا (الصين) وعسكريا (روسيا)، ولم يعد لدى واشنطن من وسيلة لحفظ صدارتها وتصدرها، سوى باللجوء إلى “البلطجة” و”التنمر” على حد تعبير قادة أوروبيين، اقتصاديا بتفعيل منظومات العقوبات الجائرة على المنافسين والخصوم، وعسكريا باللجوء إلى “الهراوة” الثقيلة ضد قواعد ارتكاز الأقطاب الدولية المنافسة، كما حصل في فنزويلا، وكما سيحصل في بقاع أخرى.
الولايات المتحدة التي خرجت بعد الحرب العالمية الثانية باقتصاد يزيد عن نصف اقتصادات العالم، لا تحتفظ اليوم، إلا بأقل من ربع هذه الاقتصادات، وما هي إلا سنوات، حتى تحل ثانية بعد التنين الصيني، وتخسر “المباراة الاقتصادية” مع بكين، وهذا ما لا تريده زعيمة الرأسمالية العالمية، وهذا ما تعمل على تأخير حصوله، بأساليب لا تليق بأعظم قوة في العالم، ولا تنسجم مع “قواعد اللعبة” التي أرستها هي بالذات، ورسمت أطرها وحددت ملاعبها ولاعبيها، من قوانين السوق إلى المنافسة الحرة والتجارة المعولمة.
لقد رسموا حدود الملعب وحددوا قواعد اللعب، وعندما شارفوا على الخسارة، انتقلوا لطرد اللاعبين الآخرين من الملعب واللعبة، واقترحوا عليهم الجلوس على مقاعد المتفرجين والنظار. لقد دفعوا للخلف بأدواتهم الناعمة التي كانت من بين الأسباب الرئيسة لانهيار الاتحاد السوفياتي ودول المنظومة الاشتراكية، فلم تعد هناك حاجة لـ”قوة النموذج” ولا لقنوات “الحرة” و”الوكالة الأميركية للتنمية الدولية”، بديل ذلك “المارينز” وحاملات الطائرات المحدثة، والقواعد التي ترابط على أبواب وحدود مختلف دول العالم.
لن تقوم واشنطن بمعاقبة خصومها، أو من يشذ عن سربها بذاتها، ستترك المهمة لـ”أزعر الحي” المنفلت من كل عقال في تل أبيب. وقد نشهد فصولا من “التوحش” و”التطاول” الإسرائيليين، لم نعهدهما طيلة عامي الإبادة والتطهير في غزة ولبنان
وفي الإستراتيجيا، ليس ثمة من نص أوضح مما تضمنته “إستراتيجية الأمن القومي للولايات المتحدة” التي نُشرت مؤخرا، والتي جعلت من “نصف الكرة الغربي”، حديقة خلفية لـ”أميركا أولا”، بعد أن أقدم ترامب على تنقيح وتعميق “مبدأ مونرو”، ليدخل الصين وروسيا وإيران، في صلب الدول المستهدفة بالطرد من جنات هذه الحديقة. وليضع يسار القارة الناهض، الأحمر والبرتقالي، في قلب دائرة الاستهداف، من على قاعدة “تنظيف البيت الداخلي أولا”، وليعيد دول القارة اللاتينية إلى عصر “جمهوريات الموز”، وإلى زمن كانت فيه الشركات والكارتيلات الأميركية، كفيلة بإسقاط هذا النظام والمجيء بذاك.
والحقيقة أننا لم نكن نظن، أن الشروع في ترجمة “مبدأ مونرو”، الذي صار “مبدأ دونرو”، سيتم بهذه السرعة، وانطلاقا من كاراكاس، وأن يتم ذلك بكل هذا اليسر والسهولة و”صفر خسائر”. نتيجة كهذه، ستفاقم غرور ترامب، وستفتح شهيته لطلب المزيد، فطالما أن “رامبو” الأميركي نجح في اختطاف رئيس وزوجته، دون خسارة جندي واحد، أو فقدان مروحية واحدة، فلماذا لا يتنقل بين العواصم المصنفة في خانة “التهديدات”؟
كان يمكن لمقاومة جدية من جانب الفنزويليين توقع خسائر في صفوف القوة الغازية على أقل تقدير، أن تشكل رادعا لترامب وفريقه، لا سيما أن الرجل التزم أمام الأميركيين بعدم جرهم إلى حروب جديدة، وتكبيدهم خسائر جديدة، وكان يمكن لخسران جنود أن يعمق شرخا قائما داخل حركة “MAGA”، قاعدة ترامب وخزان أصوات فريقه من الجمهوريين والمحافظين.
لم نكن نتوقع من فنزويلا أن تلحق هزيمة بالعدوان وأن تمنع عن ترامب انتصاره، ولكننا لم نكن ننتظر أن يجري اقتياد الرجل وزوجته، من دون مقاومة جدية تذكر، وسنترك للأيام مهمة الكشف عن ملابسات تلك الليلة “المعتمة” على حد وصف ترامب نفسه، وأن تجيب عن سؤال: هل سقطت القلعة من الداخل، وهل كان ممكنا إسقاطها بهذه الخفة، لولا “خراب داخلي مقيم”؟
في مطلق الأحوال، لم يفت الأوان على الدول المصطفة في الطابور بانتظار “رامبو” لفعل شيء معاكس، فليست “كل مرة تسلم الجرة” الأميركية، فهي لم تسلم في 1980 في” صحراء لوط الإيرانية” زمن جيمي كارتر، كما لم تسلم في العراق وأفغانستان زمن جورج بوش الأب والابن، لكن ما حدث في فنزويلا، يعطي مؤشرات قوية على خراب مستفحل واختراقات هائلة، داخل دول معادية لواشنطن عقائديا، إن لخلفيات يسارية كما في فنزويلا اليوم، أو دينية كما في إيران بالأمس.
أية رسائل ومن هم “المرسلة إليهم”؟
وبالعودة إلى “رسائل كاراكاس”، وقائمة المُرسلة إليهم، فثمة مخاطر وتهديدات لا يجوز صرف النظر عنها، حتى وإن استبعدنا احتمالات إعادة انتاج هذا السيناريو في دولنا، ويحضرنا في هذا المقام، عدد من أهمها:
أولا؛ لن يكون مجديا بعد اليوم، مخاطبة إدارة ترامب بالقول إن حكومة اليمين الفاشي في إسرائيل، تنتهك القانون الدولي وتتعدى على سيادة الدول وتنزع الحصانة عن قادتها.
هذا ما فعلته الإدارة بالضبط في فنزويلا، و “من ساواك بنفسه ما ظلم”، وسيكون بمقدور نتنياهو اليوم، أن يردد ما قاله بالأمس، بأن إسرائيل لم تفعل شيئا في فلسطين ولبنان وسوريا، لم تفعله الولايات المتحدة من قبل، وما تُكرر فعله الآن، في أماكن مختلفة وأزمنة متباعدة.
كيف يمكن لترامب أن يقنع نتنياهو بعدم ضم الضفة الغربية، فيما هو شخصيا يسعى للاستيلاء على غرينلاند مثلا، لا لشيء إلا لأنها مهمة لأمن الولايات المتحدة القومي. نتنياهو لديه ذريعة أخرى، ذات طابع عقائدي، إلى جانب حسابات الأمن القومي الإسرائيلية، لكي يحذو حذو ترامب، زعيم الغرب والعالم.
كيف يمكن لترامب أن يقنع نتنياهو بعدم محاولة قتل خصومه من قادة وزعماء ومسؤولين، بمن فيهم قادة في اليمن وإيران ولبنان وفلسطين، بمن فيهم “المرشد الأعلى نفسه أو عبدالملك الحوثي، كما هدد مرات ومرات”، فيما ترامب نفسه يدخل على مادورو في قصره، ويكبله بالأصفاد بوصفه “زعيم عصابة إجرامية؟
كيف يمكن لترامب أن يقنع نتنياهو بالكف عن المساس بسيادة لبنان وسوريا، بعد أن أطاح هو نفسه، متفاخرا، بمبدأ سيادة الدول وحصانة رؤسائها.
في منطقتنا، لن تقوم واشنطن بالضرورة، بمعاقبة خصومها، أو من يشذ عن سربها بذاتها، ستترك المهمة لـ”أزعر الحي” المنفلت من كل عقال في تل أبيب. وقد نشهد فصولا من “التوحش” و”التطاول” الإسرائيليين، لم نعهدهما طيلة عامي الإبادة والتطهير في غزة ولبنان.
ثانيا؛ من المرجح أن يجري اختزال “المهل الزمنية” الممنوحة للخصوم في لبنان وسوريا وفلسطين، وربما في العراق كذلك، لإنجاز ما ترغب به واشنطن (اقرأ تل أبيب) وسيجري التعامل بحزم أكبر، مع أية محاولات للتمهل وكسب الوقت، وسيكون المفاوض العربي في وضع أكثر صعوبة مما كان عليه من قبل.
ثالثا؛ سيفقد “تكتيك” الهروب من رمضاء تل أبيب إلى نار واشنطن، الذي اعتمده بعض القادة العرب، قيمته، وسيتعين على هؤلاء البحث عن أدوات ووسائل بديلة، للحفاظ على أمنهم القومي، واستقرار بلدانهم، وحماية أنفسهم، وهو ما يتطلب مقاربة جذرية، جديدة للغاية.
رابعا؛ إن كانت الحكومات العربية لا تخشى “سيناريو كاراكاس”، ولا تعتبر نفسها مستهدفة به، فإن لاعبين “لادولاتيين”، عليهم أن يقلقوا من قادمات الأيام، وما تستبطن من تحديات وتهديدات، فنشوة النصر التي تجتاح ترامب، ويشاطره النشوة ذاتها، وبالقدر ذاته، بنيامين نتنياهو، تحمل في طياتها إرهاصات لموجات جديدة من التصعيد والغطرسة.
خامسا؛ ما لم تُكسر هذه الموجة من العربدة، في القارة اللاتينية في مواجهة واشنطن، وفي الشرق الأوسط في مواجهة تل أبيب، فإن عهدا جديدا سيُطل برأسه البشع على الإقليمين معا، عنوانه المزيد من “جمهوريات الموز”، وستُفتح الأبواب، المفتوحة أصلا، على سيناريوهات الهيمنة والإخضاع والتفتيت والتقسيم.
فهل تشكل “رسائل كاراكاس” بداية صحوة عربية جديدة، أم إنها ستكون بداية انتقال من الغفوة إلى الغيبوبة؟
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.